
03 ديسمبر لمن ولماذا أكتب ؟ بقلم : المطران بطرس المعلم
المقالات والكتب والندوات والمؤتمرات، وحول حوار الأديان بالذات، هي أكثر من أن تحصى، وخصوصًا في هذه الأيام. وحسبُك شاهدًا “سينودس أساقفة الشرق الأوسط”، الذي انعقد أخيرًا في رومة (من 10/10/2010 إلى 24 منه)، والذي قال فيه البعض إنه سيكون الحدَثَ الأبرزَ والمنعطف الأهمّ في هذا القرن، لإرساء أسُس الحوار سبيلا إلى بلوغ السلام. فماذا كان؟ قبل أن يجفّ حِبرُ البيان الختامي للسينودس المذكور، كنا نرى ونسمع أخبار المجازر المتجلببة بعباءة الدين، في عدد من البلدان العربية والإسلامية، بحق مواطنين مسيحيين، وكان أبشعها مجزرة “سيدة النجاة” في بغداد. – فأيّ فائدة في الكتابة بعد ؟ وأساسًا هل بعدُ مَن يقرأ ؟
ولكني، وبرغم الكثير من خيبة الأمل، فالإحباطُ لم يبلغ بي بعدٌ إلى اليأس. أليس في هذا الكتاب نفسه فصلٌ بعنوان “إلى من لا يقرأ” ؟ فإن كنا لا نيأس حتى من الذي لا يقرأ، فنحن، و”بأولى حجة”، لا نزال على كبير ثقة بالذين يقرأون، من الأصدقاء الأوفياء المخلصين، وهم والحمد لله كثيرون، ومن مختلف أطياف المجتمع، في داخل البلاد وخارجها. إن لهم عليّ الفضلَ الأكبر في التشجيع وحثِّ الهمة على مواصلة الكتابة. فليقبلوا هنا عميق شكري على الصداقة وحسن الثقة.
أما لماذا أكتب؟ فلأكثر من سبب، ولك أن تتدرج في ترتيبها كما تريد. ولكنها تتجمّع كلها أخيرا في واحد. أنا أكتب أولا لأني بولسي، ورسالة البولسي تتلخص في هدفين: العمل على تقارب الكنائس ووحدة المسيحيين من جهة، ومن جهة أخرى على إقامة الحوار بينهم وبين المسلمين، بغية التفاهم والتعاون. ووسيلة البلوغ إلى الهدفين هي العمل باللسان والقلم، ولذلك أنا اتكلم وأكتب.
وأنا أكتب لأني مسيحي، في وقتٍ لا كلام فيه إلا على تناقصِ عدد المسيحيين في الشرق، وعلى هجرتهم أو تهجيرهم، واستضعاف شأنهم في تقرير مصيرهم ومصائر بلدانهم. فجئتُ لأعلن بصراحة أن المسيحيين هم في كل هذا الشرق منذ أن كانوا، قبل غيرهم ومع غيرهم، دون أنانية أو استئثار، وأنهم، مع جميع مكوّنات بلدانهم، بنَوا تاريخ وحضارة هذه الأرض، بلا فوقية ولا دونية، فلهم من ثم، وبقطع النظر عن أرقام العدد، لهم، مثلَ غيرهم، حقُ المشاركة مع جميع المواطنين في تقرير المسار والمصير.
وأنا أكتب لأني رجل دين ومطران، في وقتٍ تستعر فيه المعارك حول رجال الدين، بين متحمّس لهم، لا يأتمر إلا بأمرهم، ونابذِ لهم لا يقبل لهم أي تأثيرٍ أو نفوذٍ في المجتمع. فجئتُ لأعلن بصراحة أن الأولين قد يكونون الخطرَ الأدهى و”أفيونَ الشعب” إذا ما سخّروا الدين لمصالحَ، فرديةٍ أو جماعية، متحجرة منغلقة، أوأقحموه في ما ليس من شأنه، وأن الآخرين ليسوا أقل خطرا ودهاء، إذا ما هم أقصوا الأديان وقيَمها القويمة، واستبدلوا بها أديانا من صنع أيديولوجياتهم، فسيّسوها بدورهم “أفيونٍا للشعب”، لا يقل سُمّا وضررأ عن الأفيون الأول. أما أنا فجئتُ لأقول إن رجل الدين هو ابن مجتمعه، فله في بنائه وتطويره حقُ المشاركة كأيّ مُواطنٍ آخر، وله، مثلَ غيره، بل قبل غيره، ومن منطلق موقعه الديني والاجتماعي، حقُ التوجيه والإرشاد، على شرط أن يكون مثقفا متنورا، منفتحا على الآخرين، بعيدا عن كل تعصّب أو تطرّف متشنّج. فأمثال هؤلاء هم بناة المجتمع الحقيقيون، يبنونه بكلمتهم الرفيقة الناعمة الدافئة، وخصوصًا بمثلهم الصالح. ألا يقول المثل اللاتيني: الكلام يطير والقدوة تبقى؟
وأنا أكتب لأني عربي عائش في إسرائيل، قد اكتوى بجحيم الصراع الطويل بين الشعبين، والذي رهانُه القضية الفلسطينية. أنا أشعر وأتألم مع اليهودي في تاريخه الطويل الأليم و”محرقته” الفاجعة، ولكني أقول له إن العربي عمومًا، والفلسطيني خصوصًا، لم يكونا هما السبب في ذلك، فتعاقبَهما ب”نكبةٍ” كارثة، تذيقهما مرارة ما أنتَ عانيت. أنا لستُ من دهاقنة السياسة، الذين خلقوا المعضلة قبل سبعين عاما، ثم راحوا يبحثون لها عن حلول، ولا يزالون. ولكني، يوم جئتُ مطرانًا للبلاد، قلتُ في أول استقبالٍ رسمي: أنتم ترون المطران، في طقوس احتفالاتنا الكنسية، يبارك الشعب بشمعدانين، في الواحد ثلاث شمعات تتصالب فتُربَط مجتمعة في وحدةٍ وثيقة، وفي الآخر شمعتان تتصالبان فتُربَطان مجتمعتين في وحدةٍ وثيقة. هذا الطقس الكنسي، له عندنا مدلول ديني خاص. أما أنا فأضيفُ إلى هذا الرمز الديني مدلولا سياسيا اجتماعيا آخر، يلخّص في رؤيةٍ وتطلعٍ واضح: إن هناك شعبين وثلاث ديانات، تكون على أرض واحدة للجميع. ولكن يبدو أن هذه الرؤية كانت غاية في السذاجة، فلم ترُقْ لأساطين السياسة، ولمهندسي الحروب وتجّار الأسلحة، فراحوا يبحثون عن حلول أخرى. فعسى وليت ولعلّ، وسائر أدوات الترجي والتمني !
ولكن، قبل هذا، وبعد هذا، وفوق كل هذا، أنا أكتب لأني إنسان، ومن منطلق الإنسان. أجل، قبل أن أكون بولسيّا، أو مطرانا، أو مسيحيا، أو مسلما، أودرزيا، أو يهوديا، أو فلسطينيا، أو إسرائيليّا، قبل أن أكون من الشرق أو الغرب، من الشمال أو الجنوب، قبل أن أكون رجلا أو امرأة، قبل كل ذلك وبعده وفوقه، أنا إنسان، أحمل في نفسي، لنفسي ولكل واحد غيري، كرامةَ الإنسان، المطلق الوحيد لأنه صورة الله ووجهه ومجده على الأرض. أليس لأجل الإنسان أراد الله نفسه، في ديني وإيماني، أن يصير إنسانًا؟ “من أجلنا نحن البشر… نزل من السما ء” (قانون الإيمان المسيحي)، “وإذ هو في صورة الله…أخلى ذاته، واتخذ صورة العبد، وصار على مثال البشر، وظهر في هيئة إنسان، ووضع نفسه، فأطاع حتى الموت، موتِ الصليب” (فيليبي 2: 6-8). فهذا الإله المتجسد، الذي أحبّ الإنسان حتى الموت، قد حطم كل الحواجز بين البشر، ” فليس هناك بعدُ يهودي ويوناني، عبدٌ وحُرّ، ذَكَرٌ وأنثى، بل الجميع واحد في المسيح يسوع” (غلاطية 3: 28).
وهذا المسيح يسوع، أليس هو “المسيح عيسى ابن مريم”، ابن بلادنا، ابن جليلنا، ابن ناصرتنا؟ إن له عندنا اسمًا عَلَمًا، إنه السلام وأمير السلام وإله السلام (رومة 15: 33؛ 16: 20؛ 1 تسالونيكي 5: 23؛ 2 تسالونيكي 3: 16). إنه لم يأتِ نصيرًا لشعبٍ، أو أمّة، أوعِرق، أو طائفة، أو دين… دون آخر. إنه “سلامنا جميعا، وقد جاء ليجعل من الجميع جماعة واحدة، ويهدم في جسده حائطََ السياج الفاصل بينهم، أي العداوة” (أفسس 2: 14)، ويهدم كل جدار فاصل، أقيمَ أو يقام، في أيّ مكان أو زمان.
والكتاب الذي بين يديك ما هو إلا مسعى متواضع لإبلاغ هذه الرسالة إلى كل إنسان، ودعوة إلى كل إنسان أن ينقلها بدوره إلى غيره. وهنيئًا لكل مَن بلغته فأبلغها، فلمثله قيل: “طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناءَ الله يُدعَون” (متى 5: 9).
(هذه الكلمة هي “التمهيد” لكتابنا الجديد “من وحي الأحداث”، الذي هو تحت الطبع الآن، وسيظهر في الأسبوع الأول من العام الجديد إن شاء الله).
(بانوراما أون لاين)

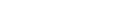

Sorry, the comment form is closed at this time.