
03 يونيو مسألة العدالة في حوار الأديان والثقافات
اشتهرت المذاهب الفلسفية والفكرية الحديثة بالإعراض عن دراسة «المسألة الأخلاقية» تارة لأنها لا تعتبرها مسألة فلسفية، وطورا لأنها لا تريد الدخول في المثاليات واللاعقلانيات، وأخيرا لأنها لا تريد الدخول في مباحث يتخللُها الدين! بيد أن ذلك انقلب رأسا على عَقِب منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي. فكما نعلمُ جميعا، حوالي أواسط الستينات ازداد التدخلُ الأميركي في فيتنام، في سياق الحرب الباردة، وسياق الصراع بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أُخرى، على كوريا وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند. وكان الصراع على كوريا (1950 – 1953) قد أَطلق الحرب الباردة، ثم جاءت الستينات لتوسع الدائرة حسبما جرى ذكْرُهُ سابقا. اعتبر الشيوعيون الصينيون والفيتناميون (والروس) التدخل الأميركي في شرق وجنوب شرقي آسيا حربا استعمارية وإمبريالية، مثل حروب القرنين التاسع عشر والعشرين في آسيا وأفريقيا. بينما كان الأميركيون (ومن ورائهم الأطلسيون في أوروبا) يعتبرون تدخلاتهم إجراءات لحماية الاستقلال والحريات من الزحف الشيوعي التوتاليتاري. بيد أن التحدي الشيوعي للولايات المتحدة والغرب ما بقي خارجيا؛ فقد ظهرت حركاتٌ اعتراضية بين طلاب الجامعات اليساريين والليبراليين، اعترضت على الحرب في فيتنام. ثم وصلت تلك الاعتراضات إلى أوساط الشبان من البروتستانت والكاثوليك. وهؤلاء الشبان – الذين كانوا يعرفون أشياء عن لاهوت الدين – هم الذين بدأوا الحديث عن «الحرب العادلة» بحسب المقاييس المسيحية في العصور الوسطى. والمعروف أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تُحرمُ على رجال الدين المشاركة في القتال أيا كان نوعُه. لكن البابا أوربان الثاني في خطابه عام 1095، الذي أَطلق الحروب الصليبية، أجاز المشاركة في الحروب الخيرة والعادلة، ومن ضمنها الحرب التي سُميت «صليبية» لأنها تجري في سبيل تحرير قبر المسيح الواقع تحت سيطرة الكَفَرة. ومنذ ذلك الحين صار القول عن هذه الحملة أو تلك، وسواء أكانت مدنية أو عسكرية أنها «صليبية» تعني أنها خيرة. ومن الطبيعي أن الذي يهبُها طابع العدالة المقدسة إنما هم رجال الكنيسة الكاثوليكية. وبعد القرن السادس عشر (ظهور البروتستانتيات) صارت عدالة الحرب تتحددُ بغاياتها أو بأهدافها، لأن البروتستانت لا يعترفون بالسلطة الدينية للكنيسة والبابا. والمُهم أن الشبان المتدينين انضموا إلى زملائهم اليساريين الجدد والليبراليين في رفْض حرب فيتنام، باعتبارها حربا غير عادلة وغير أخلاقية. وقام اليساري الليبرالي ريتشارد والزر Walzer بكتابة دراسة مقارنة عن أخلاقيات الحرب بين الفلسفات العقلانية والديانتين اليهودية والمسيحية، توصلَ فيها إلى أن الحرب العادلة إنما هي الحربُ الدفاعية وحسْب. لكنْ هل التدخلُ الأميركي في فيتنام وغيرها دفاعي؟ كان هناك مَنْ قال بذلك بالمعنى الصغير (الدفاع عن حلفاء الغرب في فيتنام الجنوبية)، وهناك مَنْ قال بذلك بالمعنى الكبير (الأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة والغرب) – بينما جاءت ثورة الطلاب بالجامعات بالولايات المتحدة وأوروبا (1968 – 1972) لتُنكر ذلك كُله، ولتُطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من شرق آسيا كلها! وفي هذا الوقت صدر كتاب الفيلسوف وعالم القانون الأميركي جون رولز Rawls بعنوان: نظرية العدالة (1971)، وهو الكتابُ الذي ظل على مدى أربعين عاما مدار نقاشٍ وجدالاتٍ متصلة بين الفلاسفة والقانونيين وعلماء اللاهوت والدين. وأهم آثاره أنه أعاد الفلسفة الأخلاقية إلى موقع الصدارة في كل التأملات ومواقع النقد والنظر. لا يُعنى رولز بعرض رؤية مقارنة، بل يذهب إلى أن «العدالة» التي هي أساسُ الاستقرار والشرعية في الدول والمجتمعات تعتمدُ في تبلْوُر مفهومها على الحس أو العُرف العام، والذي يتحول بفعل اعتماد الغالبية له إلى قوانين تدورُ بين رُكني المُساواة والحرية. ومن الواضح أنه تأثر في تكوين نظريته بفلاسفة الأنوار الأوروبيين مثل كانط وهيغل وروسو ومونتسكيو، وما خلا الأمر من البراغماتية التي قال بها الفيلسوف الأميركي وليم جيمس. وقد تعرضت النظرية لنقدٍ شديدٍ من جانب اليمين واليسار، وطُرحت عليها أسئلة لجلاء مواطن الغموض؛ من مثل: هل العدالة قيمة أخلاقية؟ ومن الذي يصنعُ العُرف المتوسط هذا في مفهوم العدالة؟ وأين تتقدم الحرية؟ وأين تتقدم المُساواة في الاعتبار؟
لكنْ كما سبق القول؛ فإنه منذ الثمانينات من القرن الماضي، ومع تقدم السؤال الأخلاقي في الاعتبار، صارت الأخلاقيات الدينية شديدة الأهمية في إضفاء طابع الشمول على قيمة العدالة، وغيرها من القيم المتصلة بها. وقد نهض لتحقيق ذلك الفيلسوف واللاهوتي الكاثوليكي هانس كينغ الذي قال بمنظومة الديانات الإبراهيمية، التي سادت منذ المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 – 1965)، ثم تعداها إلى أُطروحة الأخلاق العالمية، أو عالمية الأخلاقية المشتركة بين الأديان والثقافات والمنجزات العقلانية والعلمانية (ميثاق الأُمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان). وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي، ومع تصاعُد العودة للدين (لدى المسلمين والبروتستانت على الخصوص)، قال كينغ إنه لا سلام في العالم إلا بالسلام بين الأديان، ولا سلام بين الأديان إلا بالحوار فيما بينها، ولا حوار بين الأديان إلا بالذهاب إلى وجود قيم أخلاقية عالمية ومشتركة.
وفي التسعينات كما هو معروفٌ نشِب جدالُ وصراعُ الصدام بين الحضارات الذي قاده الإنجيليون الجدد، واليمينيون الأميركيون والأوروبيون. وقد قال هؤلاء بالقيم المشتركة والمنتصرة للحضارة اليهودية – المسيحية. وبذلك ما استطاعت أُطروحة كينغ اختراق المجال الأخلاقي والفلْسفي بسبب مساعي الجُدُد هؤلاء للهيمنة بعد «الانتصار» في الحرب الباردة. وما استطاع المثقفون العربُ والمسلمون الدخولَ في المبحث القيمي، ولا استخدام مسألة العدالة في الصراع على فلسطين. ويرجعُ ذلك لأربعة أسباب: استفراغ الجهد في الدفاع عن الإسلام في وجه أُطروحة صِدام الحضارات، وعدم الميل لربْط المسألة الفلسطينية باعتبارها حقا وتاريخا بمسألة العدالة، وعدم الميل للتسوية بين الجهاد والحرب العادلة؛ وأخيرا وليس آخِرا لعدم الميل من جانب الإسلاميين الحزبيين للارتباط بمنظومة الدين أو الديانات الإبراهيمية لأسبابٍ اعتقادية وكلامية، باعتبار أن اليهودية والمسيحية ديانتان محرفتان. وهذا في الوقت الذي عادتْ فيه الهجماتُ الإنكارية من جانب المحافظين اليهود والمسيحيين على الإسلام، وعدم اعتباره دينا إبراهيميا.
وفي السنوات العشر الأخيرة، أُعيد الاعتبار لمسألة الحوار بين الأديان والثقافات، وبرزت «العدالة» باعتبارها قيمة رئيسية في كل نقاش. وهذه الاستعادة جاءت من جانب الليبراليين الغربيين أنفسهم، على أثر الحروب الهائلة على العرب والمسلمين والتي شنتْها إدارة الرئيس بوش، ثم صارت حربا عالمية. واقترنت تلك الحروب باستيلاء الهيمنة والعولمة واقتصاد السوق على العالم كُله. وهكذا خرج كثيرون على هذا «التيار الرئيسي» وأرادوا التنفس خارج الهيمنة القاتلة وحروب الإرهاب، ومن ضمن ذلك: استعادة الحوار مع المسلمين وإعادة النظر في المقولات السائدة عن الإسلام. ومن هذا المنطلق أو هذه الزاوية، وكما تجدد موضوع الحوار بين الأديان والحضارات، تجددت اعتباراتُ ومناقشات مفاهيم «العدالة» باعتبارها قيمة كبرى في سائر الأديان والثقافات، وفي الأيديولوجيات وأنظمة الدول وقوانينها. وهذا معنى «العدالة» في أسماء كثير من الأحزاب الإسلامية، ومعنى الحوار والتحالُف في كثير من عناوين مبادرات العلائق بين الدول والكُتَل والنظُم.
ومنذ عام 2007 لاقت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات ترحابا كثيرا على المستوى العالمي. بيد أننا نحن المسلمين لا نزال بحاجة إلى قراءاتٍ مقارنة يُبادرُ مفكرونا إليها عن مفاهيم الخير العام والحضارة والحوار والعدالة، وكيف يمكننا الإسهام في النقاش العالمي الدائر حول هذه المسائل جميعا. فهناك انكماشٌ أوروبي كبيرٌ عن المسلمين والإسلام، يتجلى في طرائق التعامُل مع ذوي الأُصول الإسلامية (والعربية) من الفرنسيين والبلجيك والهولنديين والإيطاليين والألمان. ورغم صدور دراسات أكثر اعتبارا للتاريخ الفكري للإسلام؛ فإن الاعترافات بالشراكة القيمية لا تزال محدودة وقاصرة. وهناك تركيزٌ (يرى فيه البعض بشائر إيجابية!) على قراءة «الأصول الكلاسيكية المتأخرة» للقرآن والإسلام. ومع أن «قيمة العدالة» صارت أكثر بحثا واعتبارا ومتابعة في كل المُناظرات والاهتمامات؛ فإن «الشراكات» المتوقعة مع الإسلام والمسلمين على مستوى البحوث والتواصُل الثقافي والسياسي والعملي ما تحققت إلا بشكلٍ محدود. فالمنتظر – كما سبق القول – أن تكونَ المبادراتُ من جانب المسلمين (وعلى المستوى البحثي والآخَر العلمي) أكثر علمية وشجاعة وتعددا.
رضوان السيد (اشرق الأوسط)

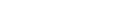

Sorry, the comment form is closed at this time.